| لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
 |
| الدكتور فهد بن سعود العصيمي |
 |
| اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعل مثواهما الجنة |
 |
  |
| صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه |
 |
 |
||
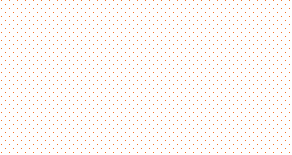 |
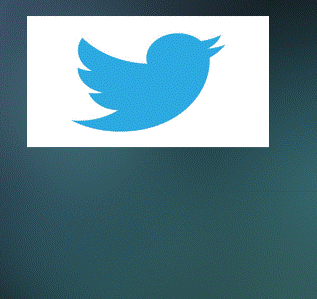 |
 |
 |
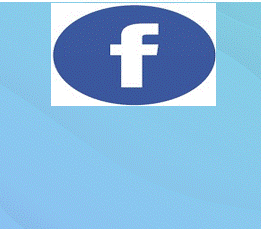 |
 |
 |
 |
مساحة إعلانيه |
| لطلب خدمة التعبير الهاتفي فضلا ابعث رسال لرقم الجوال:0568849911,أخي الزائر / أختي الزائرة مرحبا بكم في موقع بشارة خير ولتفسير أحلامكم نرجو اطلاعكم على المواضيع التالية:,منتدى التعبير المجاني بموقع د/ فهد بن سعود العصيمي,تفعيل خدمة الدعم الهاتفي (رسائل واتس أب) وإشتراك الدعم (الماسي), |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
 يا نايم إلحق الغنايم إنه صوت جدي والد أبي الشيخ أحمد العلواني العمري -طيب الله ثراه-. الله، ما أطيب هذا الرجل، وما أحلى يومه! إنه من أهم الشخصيات في تكوين حياتي، بل في حياة عائلته كلها، أبناءً وأحفاداً. إنه الإنسان الذي قال عنه الشيخ الألباني -رحمه الله-: لم أرَ في حياتي رجلاً أتبع للسنة من أحمد العلواني، وصدق والله. لا أعتبر جدي إلا رجلاً من بقية السلف في الخلف. رجل جميل الهيئة، ضحوك بسام، يألفه الصغير والكبير، عف اللسان، طيب القلب، كريم السجايا، من عباد الله الصالحين، ولا نزكي أحداً على رب العالمين. كلما زار بيتاً جمع الصغار، وسألهم: ما أول ما أوجب الله على العبيد؟، ثم يسألهم عن أركان الإيمان وأركان الإسلام، وأحاديث الصلاة. يحفظهم إياها بأسلوب سهل وممتع. حتى كنا ونحن كبار نفرح بدوران الأجيال عليها بنفس الأنغام! يحرص على زيارة أبنائه والبيات عندهم ليالي متعددة مؤانساً وناصحاً. فإذا جاء الدور في بيتنا حلَّت والله البركة والسكينة وخلَّفنا الدنيا وراءنا. يستيقظ قبل صلاة الفجر بساعتين، ويصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم يتهيأ للصلاة، وقبل الأذان بنصف ساعة يمسك العصا، ويطرق أبواب الغرف ويقول بصوت رخيم عذب حنون: يا نايم إلحق الغنايم.. يا نايم إلحق الغنايم. وكنا قد تعودنا إذا جاء إلى حينا أن نطلب من مؤذن المسجد مفتاح المسجد لأنه يحرص على دخوله مبكراً، وخاصة في صلاة الفجر قبل نصف ساعة! لا أدري والله ما الذي ملك أحاسيسه وفكره ومشاعره حتى تراه في كل ساعة بل في كل دقيقة بل كل لحظة لا يفتر عن ذكر الله، وتتحرك أصابعه بطريقة شبه (أتوماتيكية) تسبيحاً وتحميداً وتهليلاً وتكبيراً. بل حتى إنني والله استغرقت في عجبي وتأملي وأنا أراه على نفس الطريقة يحرك أصابعه اليمنى ذاكراً وهو في جلطة شبه تامة، وغيبوبة شبه كاملة. هنا أتذكر البيت الشهير الذي كان يتمثل به الإمام حسن البنا -رحمه الله-: وإذا خطرت لي في سواك إرادة يوماً حكمت على نفسي بردتي وقد شدني هذا الحال للتأمل في أذكار والدي -رحمه الله- والذي كانت طريقته كطريقة أبيه (جدي)، فوالله ما ركبت معه السيارة إلا وتحركت يده كذلك (أتوماتيكياً) على مقود السيارة، ولهج لسانه بالذكر، دون أن ينظر إلى أحد، أو يشعر به أحد! وترى أثر هذا الذكر عليهم في الخشية والإنابة، وهدوء النفس، وقوة الصلة بالله، والربانية الظاهرة، والوضاءة، والتوفيق، وحب الناس، وحفظ الله ورعايته لهم. فيالله كم بنوا من مساكن في الجنة وأقاموا حولها البساتين؟ والحقيقة أن هذه الحال قربتني جداً جداً من تأمل موضوع الأذكار بشكل دقيق، وتتبع ما جاء في القرآن والسنة وأقوال السلف، وجمعت مادة كبيرة حول هذا الموضوع، ونظرت في تأملات عالية القيمة، وغاية في النفاسة والدقة. وكنت أزكي اهتمامي هذا بدرسي الشهير في كتاب (الوابل الصيب) لابن القيم الجوزية الذي دام ثلاث سنين. وهو الموضوع الأحب إلى قلبي وأكثر ما ألقيه في الدروس العامة في بلاد الله الواسعة. رضي الله عنك يا جدي فلك بإذن الله الأجر الوفير عن كل درس ألقيته. وقد يظن الظان أن جدي المشغول بالأذكار الشرعية رجل درويش أو هو من أهل الله الطيبين فحسب. بل كان -رضي الله عنه ورحمه- آية في العلم والعمل، في أمور الدين والدنيا! أما في العلم فقد كان تاجراً مرموقاً، ووهب لأبنائه أراضي واسعة ذات قيمة عالية في قبيلته، وغدت اليوم معلماً حضارياً في المنطقة. وكان على علاقة واسعة ممتدة مع كثير من أهل العلم والوجاهة. وكان وقوراً يحب النظام جداً، ودقيق في المواعيد أكثر من الأوروبيين واليابانيين! نعم بلا مبالغة أو مجاملة. دقيق في علاقته مع الله في الصلوات، فهو يحضرها قبل موعدها، ويتهيأ لها بالحب لله، والتجمل بين يديه. ودقيق في مواعيده، ويسهم في الترتيب مع من سيوصله ويستقبله قبل الموعد، ليتأكد أن الأمور تسير بدقة. وكم مرة كنت أسمعه يقول: غداً التاسعة صباحاً نمشي، أو الخامسة عصراً نخرج، أو الواحدة ظهراً نسافر، وتجده متهيئاً مع كل ما يحتاجه في الموعد المحدد تماماً! وفوق ذلك كله هو رجل أنيق بسيط. يلبس لباساً متواضعاً، لكنه الأبيض النظيف الجميل، وتعلو محياه أنوار الطاعة التي تضيف لمسة من جمال ساحر آخاذ، وأضف إلى كل ذلك جمال كلامه وابتسامته، وحفظه لأشعار الحكماء والظرفاء ما يوظفها ببراعة في المجلس الذي يرتاده. وكان يلقي المواعظ القصيرة التي لا تتجاوز سبع دقائق كلما زار مسجداً جديداً، ويلخص كلماته العامية البسيطة في عبادة الله والخوف منه، وأداء الفرائض واجتناب النواهي، والحرص على طلب العلم، ويوصي بذلك الشباب، ويذكرهم بالمقاساة التي وجدوها في شغوف الجبال من حرمان للكهرباء والقلم والكتاب ووسائل التنقل. ولربما سمعت مواعظه عشرات المرات التي لا بد أن يختمها بقوله: (الله.. الله.. لا يرانا الله حيث نهانا، ولا يفقدنا حيث أمرنا). لقد أسر جدي بأخلاقه ودعابته ورعايته لكل أولاده بالحب والعاطفة الصادقة، وجعلهم محبين للتدين بالفطرة، وشوقهم إلى الصلاة وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب العلماء ببساطته وسماحته ونكاته، وزيارته الدائمة لهم. لم أسمعه يوماً يعنِّف أحداً، أو ينتقصه، أو يتندر بخطئه، إنما يقول مثلاً: أنا ما أحب اللي ياكل متكي -أي يأكل متكئاً-، مستدلاً بحديث النهي. نعم لم يكن على صلة وثيقة بتفريعات العلماء والفقهاء والمحدثين، ولكنه كان يملك الأسس العامة، والقواعد الكبرى في الدعوة وسبل الإنكار، حتى اختاره مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -طيب الله ثراه- موفداً للدعوة في الجنوب. ودامت بينهما أجمل أيام العمر، ووجد فيه الشيخ الألباني القدوة في السلوك والعمل واتباع السنة. وأنا إلى اليوم لم أرَ رجلاً يتحرى السنة النبوية في أدق تفاصيلها كما وردت في زاد المعاد والوابل الصيب وكتب الأذكار المختلفة مثل جدي، كأن يلبس ثوبه وحذاءه ابتداءً باليمين، وينزعهما بالشمال، ويتوقف قبل دخول الخلاء، وقبل دخول المسجد، وكذا طريقة الأكل، والجلوس! فجمع بين قول اللسان، وعمل الجوارح والأركان. رحمك الله يا جدي ورضي عنك، فقد كنت والله المثل الحي لما قاله الإمام أحمد عن شيخه الشافعي -رحمهما الله جميعاً-: لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن.
|
|
|
 خلطة التعليم
إلى فترة قريبة كان يأتني حلم تكرر عليَّ عشرات المرات، وبنفس الصيغة، خلاصته إنني لم أتخرج من الجامعة، وأنهم اكتشفوا أن مادة بقيت عليَّ من النظام لم أدرسها، وإن كنت في الحقيقة قد درست كل المواد المطلوبة وشهادتي بيدي! لعل هذا الحلم يعبّر عن حالة التنقل والمعاناة التي أصابتني أثناء مراحل الدراسة. وقصتي مع الدراسة لا أرى وصفاً يناسبها إلا (الخلطة)! فقد درست الروضة (بجدة)، والابتدائي بمدرسة (ابن زهر) بدمشق، وأول المتوسط بمدرسة (عز الدين النموذجية) بدمشق كذلك، وكنا ملمين بدراسة المواد العسكرية والفنون وحتى الفرنسية وهي اللغة التي اخترتها! ثم واصلت المتوسطة في مدرسة (حسان بن ثابت) بجدة، وبعدها دخلت (ثانوية القدس) بجدة في تخصص (الكيمياء والأحياء)، وكانت دراستي على قسمين في الثانوية قسم على نظام الثانوية الشاملة وهي نفس طريقة الجامعة في الحضور والانصراف الاختياري وتسجيل المواد حسب الطلب، وقسم منها انتظام كامل على الطريقة المعروفة اليوم. وأما الجامعة، فكانت مرحلة البكالوريوس في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بكلية العلوم في قسم الأحياء، وبعدها مباشرة درس تخصصاً جديد آخر وهو دبلوم علوم النفس من نفس الجامعة، ثم يلي ذلك تخصص جديد وهو دبلوم الشرعية العالي من جامعة أم القرى بمكة المكرمة -حرسها الله-، وبعد أن أغلقت أبواب تقديم أوراق التسجيل للماجستير، انتقلت لدراسة ماجستير الشريعة في تخصص جديد كذلك وهو أصول الفقه في الجامعة الوطنية باليمن، ليستقر بي المقام في تخصص جديد كذلك وهو (الفقه المقارن) من جامعة الجنان بطرابلس في لبنان!! ألا تظنون أن وصفة (الخلطة) هي عين ما حصل لي؟! (خلطة) في التخصصات، و(خلطة) في الجامعات، و(خلطة) في التنقلات، و(خلطة) في الشخصيات، و(خلطة) في اللغات، بل وحتى (خلطة) في الاهتمامات، والنظرات، والمنهجيات!! ودعوني أقف عند كل مرحلة أو (محطة) لأنها في الحقيقة تعتبر تجربة فذّه خاصة مع التنقلات والمقارنات وما وصلت إليه من قناعات، وما كنت مشغولاً به من اهتمامات. وأعتقد أن التركيز على نقطتي (المقارنات، والاهتمامات) الناشئة عن القناعات هو أهم ما ينبغي أن أعرض له أثناء وصف كل مرحلة، إذ إنه قد لا يتيسر لكثير من الناشئة ثم الشباب هذا التنقل لظروف عدة! ولنبدأ حكاية المرحلة الابتدائية.. فقد بدأت الدراسة وعمري (6 سنوات) إلا قليلاً، وكانت في مدرسة (ابن زُهْر) ولم أكن حينها ولا بعدها بكثير أعرف من (ابن زُهر) هذا! إلى أن قرأت كتب التاريخ الأندلسي وعرفت أنه كان طيباً أندلسياً بارعاً، خدم المرابطين، وابتكر عشرات طرق العلاج التي استفاد منها الناس . ولم أكن أتخيل في حياتي أنني سأكون رجل إعلام، وأعود للمدرسة التي درست فيها المرحلة الابتدائية لأصورها في برنامجي (مذكرات سائح2) في حلقة (سوريا)، وهي موجودة في (اليوتيوب). كنا في طابور الصباح نسمع عبارة (وحدة عربية اشتراكية)! وعبارة (أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة)! وغير تلك الشعارات التي عدت إليها بعد ثلاثين سنة بالتمام والكمال فوجدت أنها تتكرر في طابور الصباح مع زيادات اقتضاها حال العصر! ومن الطريف أنني وأنا سارح في خيالي أثناء تصوير حلقة (سوريا) وجدت الصغار يحملون (أكياس النفايات) ويقومون بتنظيف ساحات المدرسة! وهذه عادة منذ تركت الدراسة في سوريا من ثلاثين سنة، وهذه العادة الجميلة لازالت قائمة، إذ في كل يوم يأتي الدور على فصل من الفصول، ويحضرون للمدرسة وجوباً قبل حضور الطلاب لتنظيف المدرسة قبل وأثناء الفسحة! كانت الدراسة مختلطة، ولم تكن اهتمامات الصغار تدور حول الوساوس، إلابعض طلاب مرحلة الصف الخامس والسادس، وكنت في الحقيقة منذ الصغر مقاطعاً الجلسة مع صغار الفتيان، وكنت بالفطرة -والله يعلم- أقول لأصدقائي في الفسحة، (لازم الأولاد لحالهم والبنات لحالهم)!! وأكثر ما كنت أخاف منه عندما تأتي لجنة التفتيش المكونة من عشرة أشخاص لمراقبة أستاذ المادة، وقد يسألون أستاذهم الدائم الذي ربما يعاقبني إن لم أتجاوب مع لجنة التفتيش في حال لا قدر الله يسألوني عن شرح مدرسي بغتة!! كانت أمي -حفظها الله- تكثر الزيارة للمدرسة، وتسأل عن دراستي وعلاقتي بإدارة المدرسة، وهذا من أهم دوافع حبي للدراسة. ولكني في الوقت نفسه كانت تنتابني لحظات خوف وقلق من الدراسة لأنني لم أكن أحصل على التشجيع الكافي رغم وجوده بين فترة وأخرى، والاختيار المناسب لنوعية أدوات الدراسة. فقد كان والدي -رحمه الله- يتركني أشتري أدوات الدراسة لوحدي من المكتبة، ظناً منه أن اختياري سيساعد على الإبداع. وهذا صحيح من الناحية التربوية في حالة وجود الأب مع الابن. والصغير مهما كان صغيراً بحاجة إلى من يقف معه، ويسأله عن دراسته، بل ولربما يفصل نوعاً ما عن حياته الدراسية، ويديم تشجيعه. وعندي حالات عملية على نجاح هذه القاعدة أثناء تدريسي لطلاب المرحلة الابتدائية سيأتي الحديث عنها. وأخطر شيء في المرحلة الابتدائية أن يكتم الصغير مواقف مزعجة، أو يحرم من مطالب متنوعة. وأنا إلى اليوم أتذكر أنني كتمت أشياء وأشياء وأشياء، قد تبدو بسيطة، ولكنها في عمري ونوعية اهتماماتي كبيرة!! وللحديث بقية... على العمري
|
|
|
 من الحكم البليغة (النجاح سلَّم لا تستطيع تسلقه ويداك في جيبك)! من هذه الحكمة نستطيع أن نستبطن دواخلنا، فنحن نحب النجاح، والوصول إلى الغايات الكبرى التي نتمناها، ولكنَّا في الحقيقة قد نخطئ في اتخاذ القرارات الصحيحة، أو المجالات الأفضل، أو الوسائل الأنسب، (فالناس لا يخططون من أجل الفشل، ولكنهم يفشلون فقط في التخطيط)! في المرحلة الابتدائية لم يكن لي خيار في نوعية المدرسة والمدرسين، لأني درستها في دمشق، وهي من أجمل بلادنا العربية، ولكن طبيعة التدريس، والتي كانت من قبل المعلمات، وعفرتةبعض الأولاد كانت تعكر صفو المرحلة. وفي نهاية المرحلة الابتدائية ، أي في الخامس والسادس، كانت المعلمة امرأة كبيرة في السن، محافظة على الأخلاق، ومتدينة، وابنها صديقي في الصف، وهذا يعني الراحة النفسية. وأهم ما في هذه المرحلة أن يشعر الطفل بالأمان والحنان! الأمان حين الخطأ، والأمان مع بداية الضغوطات! نعم، قد يضرب الطفل في المدرسة، وقد تسرق حاجياته، وقد يهان بألفاظ جارحة، وقد يتعرض لإيذاء صديق أو جار أو قريب، وتبقى آلامها النفسية ، مالم يأت توفيق الله! والطفل بحاجة إلى حنان غير مزيف ، يحببه في الدراسة، ويحببه في الحياة، ويحببه في القيم، ويحببه في الناس. لا أدري كلما أسمع أناشيد (سنا) أو (الوردة الصفراء والحمراء) وما كتبه شعراء الأطفال (د. يوسف العظم) -رحمه الله-، و(محمود مفلح) و(سليم عبدالقادر)، وسواهم، أجد الحياة تتدفق في كل شراييني، وأحس بطعمها، وودت أن تعود لحظاتها لا أيامها، فالأيام لن تعود! ولأن (الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر)، فقد حفظت ما درَّسه لي أبي من العقيدة، وكذا جدي، وحفظت الشوارع وأسماءها، وما حصل في كل زاوية ومرتع فيها، ومما حفظته ولا زلت أتذكره جيداً، نوعية اللباس، والغطاء الذي أتدثر به، واللعب التي ألعب بها. أتذكر تماماً من كان يبيعنا الحلوى، وأدوات الدراسة، أتذكر الأصدقاء وحتى نطقهم! ولم لا أتذكر الحياة الحلوة، وقد رباني والداي عليها؟ وقبل ليلة من حديثي هذا قابلت في إحدى المطاعم صديقاً لي غاب عني عشرين عاماً، فلما نظرت في وجهة، عرفته، وذكرته باسمه، وقصصت له بعض الحكايات التي نسيها، وما منَّ به عليَّ يوماً من إفطار على حسابه! الحياة الحلوة لا تنسى بسرعة! وأصعب موقف في حياتي الابتدائية عند إعلان نتائج الاختبارات، ومعرفة الراسب من الناجح. نأتي في الصباح ونقف في الشارع كلنا، ويقف المعلم ينادي بالأسماء صفاً صفاً، وبطريقة تشد الأعصاب، ومن غير ترتيب هجائي! فإذا جاء دور الصف الدراسي الذي أنا فيه، ومعي قرابة خمسين طالباً تجدني في مرحلة صعبة، حتى أنني أتذكر أن اسمي (علي) جاء مرة قبل الأخير! لقد مررنا بحالات نفسية صعبة ، بل صعبة جداً، فكيف لا تكون مرحلة الطفولة هي مرحلة بناء المشاعر؟! وأتذكر قبل بضعة أسابيع قابلت صديقاً حبيباً يصف لي المدرسة الجديدة التي يشرف عليها، وهي في مدينة جدة، وتدرس المرحلة الابتدائية فقط، يدرس فيها الطلاب اللغة العربية والإنجليزية، وبعض المواد الدينية، والحديث كله بين المعلمات والصغار بالإنجليزي، ويدرسونهم فيها كيف يبيعون ويشترون، ويعطونهم أموالاً غير حقيقة ليتاجروا، فيقولون لهم: اذهبوا إلى التاجر الفلاني، وانظروا أسعار البورصة، واسألوا عن الشحنة التجارية، وأنهوا إجراءات الجمارك...! وأحيناً يدخلونهم غرفة طبيب الأسنان ، وفيها أدوات غير حديدية، ويجرب الصغار دور طبيب الأسنان (بالدور)! كما يعلمونهم صناعة الأفلام القصيرة، لأن بحث التخرج في السنة الثالثة الابتدائي عبارة عن فيلم قصير مدته ثلاث دقائق، تقيمّه مشرفة تأتي خصيصاً من كندا! وذكر طرفة مفادها أنه بعد الأسبوع الثاني من الدراسة سأل الأباء إدارة المدرسة: لقد اشترينا (الشنط) للأولاد، فأين الكتب؟ فقالوا: الدراسة هنا من غير كتب!! صمتُّ في نفسي وأنا أسمع وأشاهد الصور عن هذا الواقع الجديد للصغار، وقلت: ما أعظمه وأجمله، لقد فات علينا، ولكن لم تفت علينا حياة المشاعر!!
|
|
|
 عندما كنت مراهقاً! المراهقة في الحقيقة ليست متعلقة بسن محدد، بل هي متعلقة بالرَّهَق! فمن الناس من تبدأ مراهقته منذ المرحلة الابتدائية، ومنهم من تبدأ بعد ذلك! فأنا تعبت نفسياً في المرحلة الابتدائية أكثر من المتوسطة والثانوية وما تلاها! ففي الابتدائية كان جوّ دمشق الشام شديد البرودة، وكان جدول اللقاء بالأصدقاء صعباً، وكان أقربائي بعيدون عني، وكانت القيم التي أتعلمها من والدي كالصلاة وألوان الطاعة واحترام أهل الفضل والعلم، محفوفة داخل البيت، ومع بعض أصدقاء الوالد، بينما كانت المتعة غير بريئة في خارجه! والسبب باختصار عدم تحبيب كثير من العوائل لأولادها معنى الصلاة، وعدم وجود برامج هادفة، خاصة إذ عرفتم أنني كنت هناك فترة (1979-1985م)! أي فترة (ضرب الحركة الإسلامية في سوريا)، والتشديد على البرامج الهادفة. وأتذكر ونحن في عمارة كبيرة أدوارها عشرة، وشققها ستون شقة -ولكم أن تتخيلوا هذا العدد الكبير من الشقق في عمارة واحدة، وما يمكن أن يحصل فيها من عفرتةالأولاد- أنني لم أعرف من أصدقائي من كان يُصلي أو يذهب معي للصلاة في المسجد سوى صديق واحد في الدور العاشر، وبعد ذلك أحد الأساتذة الفضلاء الذين هداهم الله بالفطرة كان يصلي بنا إماماً في شقته ومعي أربعة من أصدقائي كنت أحضرهم له في الصلاة، حيث كانت أغلب صلواتهم ابتسامات، لأنهم أتوا مجاملة لي!! وفرح والدي كثيراً بوجود مجموعة يسيرة في العمارة تحافظ على الصلاة، وكان هذا الأستاذ يذهب كل عصر عبر الباص إلى محل الحلويات، ويشتري لنا (حلاوة نارجين)، ويلتقي بنا في صلاة المغرب في شقته، فيصلي بنا، وأحياناً يقدم واحداً منا لتشجيعه، وبعد ذلك يقدم الحلوى مع العصير أو الشاي، ويلقي خواطره الإيمانية، وأحاديثه الرقيقة، وكانت هذه الجلسات من أعظم جلسات حياتي، وكنت وقتها في الصف الخامس إبتدائي. وأتذكر كذلك أن أستاذاً من عائلة (الطحان) كان يجمعنا في داره بعد الانتهاء من الدراسة مباشرة يوم الخميس، وهو آخر أيام الدراسة في سوريا، وفي فترة الظهيرة أي قرابة الثانية ظهراً نجتمع في بيته وعددنا قرابة الخمسين، فيلقي علينا درساً تربوياً رائعاً، لازلت والله أتذكر أحداثه، وطبيعة اللقاء، وفرحتي غير العادية به، وإلى يومي هذا أقول في نفسي: سبحان من هيئ هذه اللقاءات في مثل تلك الظروف! ورغم هذه اللقاءات القليلة والهادفة والمؤثرة، إلا أن الشارع العام بعمومه لم يكن مرضياً، ولم تكن البرامج التلفزيونية تسر، وفي هذه المرحلة كانت تساؤلاتي الداخلية أعمق وأكبر بكثير من المرحلة المتوسطة. وكانت المواقف التي أشاهدها وأعاصرها في المدرسة وفي الطريق تشدّني أكثر لأعرف كيف يفكر الصبيان! حتى إنني في مرة من المرات كنت أتابع مسلسل الأطفال الكرتوني (توم آند سُوْيَر)، وهو بالمناسبة موجود على اليوتيوب، ولا يعرفه أكثر شباب اليوم! المهم أن هذا المسلسل التلفزيوني الكرتوني كان فيه جذب غير طبيعي، ومغامرة لا نظير لها! وفي إحدى حلقاته أنهم كانوا يتمرسون على صناعة القوس والسهم، والهجوم بها ضد كل من يعاديهم. وأتذكر في تلك اللحظات أن بعض الجيران كانوا يرفعون أصواتهم علينا عندما نلعب الكرة، ولربما أوقفوا سياراتهم عناداً في ناحية ملعب العمارة، فقلت لأصدقائي: فلنفعل ما قام به (توم آند سُوْيَر)!، أي نضع الأقواس والسهم الخشبي ونرمي بها عليهم، وهذا ما حصل حقاً!! أعتقد أنني في تلك المرحلة (الابتدائي) كنت أمام تيارات متعددة! تيار البيت المحافظ الذي أنتمي إليه، وأحبه، وأطبق كل ما يدعو إليه، وتيار التلفاز ببرامجه الطفولية الكرتونية الثائرة، والتي تدعو للخيال والخروج عن المألوف، والتمرد على الواقع للاستكشاف على أقل تقدير. إضافة إلى حماقات بعض الأصدقاء، وتصرفاتهم المشوهة أو المشبوهة! وعندما دخلت المرحلة المتوسطة التي يفترض أن تكون الأصعب، والتي يسمح فيها الإنسان لنفسه أن يجرب، لأنه خرج من عالم الطفولة كما كان يقول لنا الكثير وأهمها مدير المدرسة الابتدائية في حفل التخرج، أقول: لقد خرجت من الابتدائية إلى المتوسطة وأنا بفضل الله، أحسن حالاً نفسياً، وأكثر تمسكاً بما أؤمن به وأتطلع عليه، وكانت كل المواقف والأحداث التي أسمعها أو أرى بعضها -يعلم الله- لا تحرك فيَّ ساكناً! ولكني وبعد مرور عقود من الزمان ، أتذكر المرحلة الابتدائية أكثر من المتوسطة، وأتذكر مقالبها وأخطاءها، وبعض جمالها، وكيف كنا ننظر للحياة حينها!!
|
|
|
 أول فتاة أحبها! صحيح أنني في المرحلة الابتدائية، وأنني قطعاً غير بالغ!، ولكنني رغم ذلك أحببت إحدى الفتيات!
ليس السبب هو أن المدرسة الابتدائية التي تعلمت فيها كانت مختلطة، فليس في هذا المكان ولد مشروع الحب هذا. وليس السبب في العمارة التي كانت خليطاً من الأشكال والألوان ومدخلها الرئيسي واحد. والحب يدخل القلب لا تعرف له مدخلاً، ولا تدرك له سراً! دخل حب هذه الفتاة لأول مرة في حياتي ، وإن كان يجوز الاستغفار وقتها، وأدركت قيمته لفعلت! بدأت حكاية هذه الفتاة عندما زارتني أول مرة في بيت الأهل، وربما كنت وقتها لوحدي، أو بصحبة أحد إخواني، لا أدري. نشأت علاقة لطيفة ، وأخذت من أول انطباع أميل إليها. نعم هي فتاة، وصغيرة، ولم أكن أدري وقتها في أي سنة تدرس، ولا في أي حي تسكن. وجرَّ اللقاءُ اللقاءَ في مواعيد ثابتة ، ولكن برضى الوالدين! أخذت من شخصيتها دون أن يدرك الأهل ذلك. فهي رشيقة، أنيقة، مألوفة، بريئة، تحب الخير، مبتسمة، اجتماعية، تعشق الطبيعة، تهوى المرح. آهٍ، كنت أتمنى أن أحتفظ بذكر اسمها لنفسي، ولكني آثرت أن تشاركوني معرفتها، والترحم على أيامها. إنها صديقتي التي تعرفت عليها لأول مرة، وتسمى (هايدي)!! نعم (هايدي)..! أول مسلسل كرتوني أشاهده ، أشاهد البراءة، والطفولة، أشاهد العالم من وراء الجدران، أشاهد الجَمال، بل أشاهد السماء والغيوم من عيون (هايدي). كان يُقال عن (هايدي) في (تتر البداية): عاشت حياتها في الحب والخير. وهما أصدق كلمتين تعبر عن الطفولة، فهل سمعتم أبلغ وصفاً منهما؟ الطفل يمنح الحب للآخرين ، ويمنح الخير ، وأحلى وأجمل الخير الذي يحمله (الابتسامة) التي تعوِّض عن كل هم، وتفتح صفحة جميلة جديدة! لم أعرف في حياتي -والله يعلم- سوى (هايدي)، ثم فتاة صغيرة كانت جارة لنا، قابلتها وأنا في الصف الأول ابتدائي، عند زيارة أهلي لبيتهم، فعرفت اسمها، ومدرستها، وبعض صفاتها كالهدوء حيناً، والشقاوة حيناً، ولم أجلس معها بعدها في حضرة أهلي، اللهم إلا إذا أحضرت عند باب شقتنا طعاماً يُدعى (تسقية) وهي أكلة شامية جميلة، إذا استهوتني نفسي لأكلها، أطلب من صديقي السوري (محمد نور) أن تعدها أمه، فهي ماهرة في طحنها، مميَّزة في علمها! ولربما أتت أحياناً بصحن (مجدَّرة)، وهاتان الأكلتان الوحيدتان اللتان أحببتهما وعرفتهما، فلا أردي هل نبع حبهما لجمال الطعام، أم لأخلاق مقدِّمة الطعام؟! وبالعموم، كان هذا الحال ما بين الأول والثاني ولربما الثالث الابتدائي لا أكثر، وأما الجلوس بحضرة الأهل فهي المرة الوحيدة في الأول ابتدائي. وبعدها لا أعرف في حياتي فتاة أنثى غير أختي الوحيدة والحبيبة والحنونة والرحيمة التي هي مفخرتنا وتاج رأسنا، والخلوقة دوماً بيننا. وحصلت حادثة وحيدة خرقت هذا الحال ، أنني وأنا في الصف الثاني ابتدائي، (قرقرت) بطني ، أي: جاعت! وكنت يومها أبيت في بيت عمتي وجدي في آن واحد، فحدثت ابنة عمي عن داء الجوع! فأَخَذَتْ (قِدْراً) من تحت سرير حديدي، ووضعت فيه رزاً، أخَذَته من (خيش) في المطبخ، فسألتها: هل تعرفين طبخ الرز؟! قالت: سأفعل كما تفعل أمي. وكنا في الغرفة أربعة أو خمسة! فدخلت وطبخت (الرز) لمدة ساعة دون أن يستوي، وإذا سألتموني، ما السبب، قلت: الفيلم انقطع!! أي: أنني نمت بعد طول انتظار! هناك -أيها الأحبة- أناس مهووسون بذكر الأنثى ، وأن لا جمال إلا في مؤانستها، ومشاركتها همها وفكرها وطموحها! والأنثى كائن مستقل، ومخلوق فريد جميل، تشارك الرجل في الشأن العام، والحديث العام، وتشاركه خصوصياتها يوم تسعد به زوجاً. وعندما يكون الفتى والفتاة عاقلين ، سيدركان تماماً أن العلاقة الطيبة، بالذكر الطيب، والكلام المهذَّب، والتعاون الصحيح، واحترام الخصوصية، إن وجدت الحاجة، مع الصيانة، والوضوح، وفي المكان العام، ومراقبة الرقيب، كل ذلك له وقته، وحدُّه. والأيام تزيدني في احتراماً للأنثى، ولكن بتقدير خصوصيتها!! يتبع
|
|
|
 إنه عام 1979م في سوريا! يكفي ذكر هذا العام لمعرفة مسلسل لم ينتهي إلى هذه اللحظة! يكفي أن تتذكر هذا العام لتدر الذاكرة بكل تفاصيل ذلك العام وتجاعيده المشوَّهة. إنه العام الذي دُمرت فيه (حَماة)، وقُتل فيه الآلاف، وعذب فيه الآلاف، وشرِّد فيه الآلاف. مأساة (حماة)، في عام (1979م) أو مأساة (الإخوان المسلمين) في سوريا. نعم كنت صغيراً حينها، وفي المرحلة الابتدائية، لكنني شاهدت صوراً متعددة كانت تستبطنها الذاكرة وإن لم أكن أحمل خيوطها كاملة لأنسج بفطرتي ما كان يحصل، حتى وإن كانت السياسة لا تعرف أو لا تعترف بالفطرة! شاهدت عند الإشارة المرورية شرطية سورية تطوف بين السيارات، سيارة سيارة، ولكنها لا تقترب من سيارتنا لأنها تحمل لوحة (دبلوماسيِّة) بحكم طبيعة عمل والدي قنصلاً سعودياً في دمشق آنذاك. سألته عن سر تحرك هذه الشرطية بفضول، فأجابني بصراحة مذهلة: إنها تبحث عن النساء اللواتي يتحجبن!! وصمت أبي بعدها، وتركني في اللاشعور، ولم يدرِ -رحمه الله- أن هذه القصة بحادثتها الأليمة بقيت عقوداً من الزمان لم تُمح! وشاهد آخر عند وقوف باصات كثيرة عند باب عمارتنا، فسألت والدي عنها، فقال: هذه تتعلق بأناس اسمهم (الإخوان المسلمين)!! ولا تعليق كذلك منه بعد هذه الكلمات العفوية الصريحة! لم أفهم حينها الأمر، إنما فهمت تركيب الحوادث، وأن فيها صوراً بشعة! بعد هذه الصور بفترة وجيزة وفي حدود عام (1981م) سمعت شريطاً مسجلاً بعنوان (نحن جدار الصامتين) للشيخ الكبير والخطيب البارز (أحمد القطان). وصل هذه الشريط مع جملة من الأشرطة كنا نحصل عليها من السعودية عن طريق الأقارب كآخر الإصدارات في السوق، وكانت أشرطة الشيخ القطان هي الأكثر والأبرز، ولم تكن ثمَّة ما يسجل عنها رضاً أو سُخطاً! وصل إلينا الشريط واستمعت إليه، وإذا بالشيخ يتحدث عن رسالة وصلته من سجون حماة، كتبتها امرأة مسلمة تصف المعاناة والويل الذي قاسته هناك. وقفت حينها كل شعرة في جسدي، وأصابتني القشعريرة، وأخذت أسأل من لحظتها عن حقيقة المأساة وتفاصيلها وأنا صغير، فطلب مني غير مرَّة السكوت، أحياناً بلطف، وأحياناً بـ...! ولكن وللأسف لم تكن لتمر هذه الواقعة بسلام، أو يتنازل جزء من دماغي عن تخزين وقائعها. نعم لم تكن الصورة مشوشة، بل كانت مستفزة! ومنذ ذلك الحين وإلى يوم الناس هذا، وأنا أقرأ عن هذه الحادثة كل شيء امتدت له يدي، وأتسمَّر عند كل برنامج لقطت أذناي نبأه. أعلم تماماً أنه من الظلم الإفصاح في سطور عن خلاصة ما تتبعّته بدقة، وما قرأته بعمق وتفصيل دقيق، بل أزعم أني جالست الكثير والكثير لمعرفة الآراء المتناقضة أحياناً، والصور المختلفة بين الوقائع، ولربما المختلطة. نعم لن أعيد الماضي، ولن أكون قاضياً لأحاكم أحد، ولكن لأفهم المشهد السياسي بوضوح وعمق، وإن كان الدخول في الأعماق يقترب من الظلام أو الظلمات!! هنا وبلغة عصر السرعة يمكنني أن أقول: إن مأساة (حماة)، هي حادثة أليمة دُمِّرت فيها هذه المدينة الجميلة بشكل شبه تام، وقتل فيها عشرات الآلاف من الكبار والصغار، والرجال والنساء، وشرِّد فيها علماء وفضلاء عرفنا نخباً كثيرة منهم في بلادنا وفي أرجاء العالم الفسيح! ولعل في صور الكتب والروايات والأفلام وبعض مقاطع (اليوتيوب) ما يدل شيئاً ما عما نتحدث! بدأت المأساة بصدمات محدودة ومتقطعِّة بين الحكومة وبعض الدعاة الذين خرجوا عن فكر (الإخوان المسلمين) في سوريا أو فهموا الفكر بمنظورهم الخاص، ومالوا إلى العنف والتطرف والتجمّع إزاحة الحكومة البعثية القومية، ومنطق القوة إذا سيطر على العقل، فالفكر يتلاشى غالباً!! فكانت التجمعات والتحزبات والعلاقات مع دول مختلفة! ثم كان الصدام المسلح في علميات متفرقة، أحياناً بين أفراد، وأخرى بين مجموعات. ومع محاولات المصلحين من العلماء والدعاة للم الشمل، وحصر المشكلة، واستيعاب ما يمكن استيعابه، إلا أن الفتنة العمياء سيطرت، لأن لغة السلاح لا تسمح بالتفاهم!! فقررت الحكومة السورية شلّ أكبر تجمع دعوي لأصحاب فكرة المقاومة المسلحة. إن تداعيات الحادثة وملابساتها المتقطعة والمتشابكة رغم وضوح تفاصيلها قبل الحادث المشؤوم، إلا أنها في المآل تعود لفكرة التطرف والعنف الذي يقضي على كل تفكير أو رغبة في التغيير. ولا أدل على ذلك من بلد المليون شهيد (الجزائر) الذي لم يستفد دعاة العنف فيه من تجربة (حماة) وللأسف!! والدعوة إلى العنف دعوة متراكبة مختلطة في صورة غير منسجمة فكرياً ونفسياً. ولعلَّ في كتابي (الشباب .. بين الجهاد والإرهاب) مزيد توضيح، وكشف عملي، واستقراء ميداني، وتحليل منطقي لترابط الضعف العلمي، واليبوسية البيئية، والإضراب النفسي، والتعرض للإيذاء، للمقاومة بعنف مضاد، لا ينبع من دين، ولا يستوعبه عقل!! لم أكن أود أن أروي فصولاً مأساوية في ذكرياتي هذه بشكلها البشع، ولكنها الحقيقة التي لابد أن تستقر في العقول قبل الوجدان. ولأثبت قيمة هذا المعنى، كنت أسأل بعض السجناء الموقوفين بسبب العنف في السجون السعودية من الشباب الذين لا يتجاوز عمرهم الخمسة والعشرين عاماً: هل سمعتم بمأساة حماة ومشكلة الجزائر؟! فقال لي الجميع: لم نسمع بهما!! فهلاَّ عذرتموني إذاً على طرح هذه الصفحة السوداء من الذاكرة؟! على العمري
|
|
|
 الحس الغنائي والعسكري في المتوسطة ربما يكون بيني وبين المفكر العراقي الكبير (علي الوردي) تشابه إلى حد بعيد! فهو عندما حفظ القرآن فرح والده بهذا الخبر فرحاً كبيراً، وأقيمت له (زفَّة) من الكُتَّاب إلى البيت! وأنا عندما أخبرت والدي بإتمامي حفظ كتاب الله ، دعا بعض الأقارب في حفلة خاصة! وعندما وصل (الوردي) إلى المتوسطة اضطر إلى لباس البنطال والقميص والطاقية، ولم يكن هذا الزي مريحاً له لأنه كان يميل إلى اللباس العفوي وما اعتاد عليه من الجلابية والقبعة الخضراء! وأنا كذلك ما كنت أميل إلى هذه الملابس ذات اللون الزيتي الغامق الذي لا تفاؤل فيه ولا معه! درست المتوسطة في دمشق وتحديداً في منطقة (المزَّة) وكان اسمها (عز الدين التنوخي) ! وأذكر أن لهذا الرجل (عز الدين التنوخي) فضل عليَّ كبير لنا أنساه طول حياتي! وذلك أني في المرحلة الثانوية كنت مدمناً على قراءة كتب الشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله-، وكنت أتابع مع أهلي برنامجه الأشهر (على مائدة الإفطار)، وأعجب بأسلوبه الجميل، وعفويته، ولغته الشامية التي أميل إليها لأني درست فيها! لكني لم أكن أتوقع أنه أديب من الطراز الأول، وكاتب مبدع ساحر في البلاغة و(رهيب) في التأثير! نعم لأن برنامجه التلفزيوني لم يكن يفصح كثيراً عن مواهبه. وذات يوم وأنا أتجول في مكتبة البيت العامة، وجدت كتاباً صغيراً عنوانه (القضاء في الإسلام) للشيخ علي الطنطاوي، وأذكر أني مررت أكثر من مرَّة عليه، ولكني لم أمِل لتصفحه لأن العنوان غير مغرٍ لشاب في المتوسطة! أخذت الكتاب وقرأت أوله ، وإذ بالشيخ يذكر في هامش الصفحة الأولى أن أصل المكتوب محاضرة له كانت في إحدى مواسم الحج! فتعجبت وقلت في نفسي: ما علاقة هذا الموضوع بالحج، وما الجديد فيه؟ ومع أول سطور الكتاب أسرني الشيخ ببراعة أسلوبه، وقوة بيانه، وجاذبيته التي تطربك وتسرق مشاعرك في آن واحد. لقد حفظت المقدمة تماماً بحروفها، لأني لأول مرة أطرب لهذا الأسلوب الرائع، والذي كان فاتحة الشهية لقراءة كل كتبه بعدئذ. أعود لاسم مدرستنا في المتوسطة (عز الدين التنوخي) وصاحبها. بنهاية المرحلة الثانوية كنت قد أتممت بتعمق ما كتب الشيخ الطنطاوي وخاصة ذكرياته التي أثَّرت فيَّ كثيراً. وعزمت على زيارة داره إلى أن حان القدر وأنا في أول المرحلة الجامعية، وقد عرفت أنه يسكن في عمارة (التأمينات الاجتماعية)، في جدة، في نهاية (شارع باخشب). وصلت إلى العمارة التي دلني عليها أحد الأصدقاء بعد صلاة الظهر! وهل يا ترى بعد الظهر يزور أحدٌ أحداً بلا موعد؟ إنه حب الشيخ وكفى! العمارة كبيرة، وبدأت أسأل حتى هديت لرقم المدخل والشقة. طرقت الباب، فردَّت علي (شغّالة أندونيسية)، فقلت لها: هل الشيخ علي الطنطاوي موجود، قالت: نعم، فقلت: وهل يمكن أن أسلِّم عليه فقط! نعم كان هذا هو كل همِّي ورجائي ، ودعوت الله بعد صلاة الظهر أن ييسر لقاءه، فقد حاولت كثيراً الوصول إليه، وفي مخيلتي عشرات القصص، المدججة بالمواقف ضد المستعمرين، وفي ساحات القضاء، وفي مراتع الصبا، بل وأمام التلفاز، إضافة إلى الصور المعبِّرة والمشوقة والآسرة في نهاية ذكرياته. وما إن قالت لي الخادمة: تفضَّل، وإذ بالفرحة تدب في كل جوانحي! دخلت أول غرفة على اليمين، وإذ بالشيخ الوقور الحبيب إلى قلبي علي الطنطاوي جالس على كرسيه، يرتدي (بشتاً) بنياً، وهو حاسر الرأس. سلَّم عليَّ، وصمتُّ من هول الموقف! ثم سألني الشيخ متعجباً من الدخول والزيارة هذا الوقت: هل لديك أمر طارئ يا ولدي؟ فقلت له: لا يا شيخ ، إنما أردت زيارتك! فقال: ولكني لا أستقبل هذا الوقت، إنما بعد العشاء فقط ، ولك أن ترتب مع زوج ابنتي السيد: محمد نادر. شكرت الشيخ على هذا الأمر ، ووعدته بأن أرتب معه الموعد بعد اتصالي بداره العامرة التي يملكها (دار المنارة) الموزعة لكتب الشيخ. ولكني أخبرته على وجه السرعة، عن دافع الشوق الذي دعاني لزيارته دون أن أشعر بالوقت الذي أتيت فيه، وهو حبي له، وقراءتي لكتبه، وخاصة صوره التي ذكرتني بالشام عندما كنت طالباً فيها! هنا انتفض الشيخ، وقال: هل درست في الشام؟ قلت له: نعم، قال: وأين درست؟ قلت: الابتدائية في (ابن زُهر) والمتوسطة في (عز الدين التنوخي). ففرح كثيراً، وقال: (عز الدين التنوخي)؟! وأخذ يسرد لي من هو عز الدين التنوخي ، وحياة هذا الرجل العظيم. ولما فَرغ، قال للخادمة: أحضري لنا طعاماً وضيافة! وأكرمني بالضيافة، فحدثني عن بعض كتبه، فأجبته بمعرفتها وحفظ دقائقها وتفاصيلها. فدهش من إجاباتي، واستنباطاتي، وتأملاتي ، بل وحكايتي مع كتبه قبل النوم منذ المتوسطة إلى الثانوية. وبينما هو في سروره ودهشته ، وقد أخذت قرابة الساعة! دخل علينا الأستاذ: محمد نادر حتاحت ، فحدثه الشيخ عني، وعن دراستي، واهتمامي بكتبه، وما جرى بيني وبينه خلال تلك الساعة، وعبر عن اندهاشه بمتابعتي وتأملاتي في ما كتب، ثم قال للسيد محمد: للأخ علي أن يأتي في أي وقت! ومن بعدها لازمت داره كل أسبوع من يوم الثلاثاء بعد صلاة المعشاء مباشرة -رحمه الله-. أعود إلى مدرسة (عز الدين التنوخي). لم تكن المدرسة مختلطة كما في الابتدائي ولا الثانوي كذلك، وهذا من عجيب الدراسة في سوريا، فأول مراحل الدراسة (الابتدائي) مختلطة، والأخيرة (الجامعية) مختلطة، وما بينهما كل حزب بما لديهم فرحون! لم يكن من شيء مثير تلك المرحلة سوى ثلاث أمور. الأول: أنه لم تكن هناك أي مادة للدين، سوى مادة عامة ليس لها مدرس مختص، إنما في كل مرحلة يدرسها أي شخص! وهي مادة عامة في الأخلاق والقيم الكلية. الثاني: أننا كنا ندرس مادة التربية العسكرية، وفيها تدريب عملي عسكري، يزداد ضراوة حيناً، ويخف حيناً آخر، إضافة إلى دراسة نظرية للأسس والقواعد والمفاهيم العسكرية العامة! الثالث: دراسة التربية الموسيقية، من خلال الدرج الموسيقي، والتدريب على المقامات والألحان الصوتية، وأداء كل طالب مقطعاً صوتياً غنائياً لإحدى المغنين أو المغنيات المشتهرين تلك الفترة (فيروز، عبدالحليم، ميَّادة الحناوي...)، ويقوم الطلبة في الفصل بتقويم صوته، ومدى تطابقه مع النغم والدرج الموسيقي. وعندما كان يأتي الدور عليَّ للغناء، كنت أقول للأستاذ: أنا سعودي!!! وقد أخبرت والدي برفضي لهذا الطلب، فأتى إلى المدرسة وأقنع الإدارة بأن حضوري إن كان ملزماً، إلا أنني سأمتنع عن الغناء والأداء لعدم قناعتي، وأكتفي باختياري في معرفة الدرج وطبقات الصوت واللحن والنغم !!
|
|
|
 شقاوة العمر اللطيف! كثيرون يتحدثون وينبهون أن مرحلة المتوسطة هي أخطر وأتعب مرحلة يمر بها الشاب وأهله ! وكثيرون يقولون: إنها مرحلة المغامرات، وتشكيل القناعات، والخروج عن المألوف، والتمرد على النفس، والبدء بالعصيان المدني ! ولكن في الحقيقة يمكن القول: إنَّ هذه المرحلة يمكن أن تمر بسلام، وأن تكون هي المحفز الأقوى للصمود والعطاء والتمرد الإيجابي!، وهذا التعبير ليس بالضرورة يفهم في سياق قلتهم، إنما في سياق قوتهم وتماسكهم، والإعجاب بسلوكهم وعطائهم. المرحلة المتوسطة باختصار تحتاج أمرين اثنين: 1- بيئة جيدة. 2- تربية مميزة. وأنا على استعداد أن أتحدى بهذين الأمرين أعتى وأقوى من يحاول أن يؤثر على الشباب بكل عددهم وعتادهم! لقد واجهت في المرحلة المتوسطة أخلاطاً من الشباب، لكن التربية المميزة، وبيئة المسجد، والجلوس فيه، والتشجيع على حفظ القرآن الكريم، كانت تواجه كل مشكلات الشباب بحزم، ولا تشارك في مغرياتهم أو فزعاتهم الوهمَّية! كان خطاب (الأنا) عميقاً وعميقاً جداً. وأحياناً كنت أخرج عن هذه الدائرة والبيئة أحياناً فأكتشف خطئي بسهولة، وأحس أنني قصَّرت في بعض العبادات. مرة أخرى كانت أعماقي مليئة بجانب الخوف والخدر، مليئة بمفهوم الحساب والعاقبة، مليئة بمعنى "احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك". ولو لا هذه المعاني القوية لكنت شاباً عادياً! لا أزعم عدم الخطأ ، أو ممارسة فكرة أو تصرف غير محمود، لكنني أصدق نفسي أنني كنت مشبعاً بدرجة مميَّزة من طُهر البيت، والتذكير بالرقيب! ولذلك فإنني عندما أرى اليوم حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي يدرس فيها شباب المتوسطة أفرح يعلم الله فرحاً شديداً، وأدعمها بكل ما أملك، وأرى نور المستقبل كلما رأيت محافظتهم وسمتهم الصالح البريء! ولا أكتمكم سراً أنني كلما رأيتهم استبشرت خيراً بمستقبل ابني (حمزة)! دخلت في الصف الثاني متوسط مدرسة (حسان بن ثابت) بحي الجامعة بجدة، وكانت مدرسة عادية جداً، لم تعجبني طريقة طابور الشراء من المقصف، كما لم تعجبني آلية طابور الصباح! فمرحلة الأول متوسط في سوريا لم يكن طابور الشراء ولا الوقوف بمثل هذا التخلف من الازدحام الشديد حتى يضيع وقت الفسحة. ولا التخلف في الأماكن التي لا يستطيع المرء الجلوس لاستنشاق الهواء الجميل، أو الراحة في الحركة، والسبب باختصار: أن (الفسحة) كانت فترة لمباريات الفصول، وبالتالي الملعب أو (ساحة المدرسة) مشغولة تماماً!! ومن هنا فإن مثلي لا يهوى (الكرة) لن يستمتع في الساحة لا بالحركة ولا بالقراءة ولا بأي نشاط، لأن الأصوات المزعجة في المباراة هي سيدة الموقف! كان هذا العام (1405هـ)، لم يكن هناك أستاذ عليه أو منه خصال التدين الشامل المحمود، فالأغلب يسب ويشتم ويضرب بمن فيهم أساتذة الدين، حاشا رجلاً خمسينياً كبير السن، معه (العصا) فقط!! نعم لم يكن يسب أو يشتم لكنه كان يضرب بالخيزران كل من هب ودب! قبل نهاية مرحلة الثاني متوسط، طلب مني هذا المدرس الكبير أن أكون مندوباً عن المدرسة وممثلاً لها في رحلة ستقام لمدة يومين لكل مدارس المتوسطة في جدة، والعجيب أن مكان الرحلة مدرسة كذلك!! قلت حينها للأستاذ: ولكن ألا يمكن أن آخذ معي طالب آخر للمشاركة؟ فقال: من ترشح يا ولدي؟ فقلت: فلاناً، وكان شاباً مصرياً مهذَّب الأخلاق لا ينبس ببنت شفة! فوافق المدرس، وحضرت أنا وصديقي ممثلين عن المدرسة. كان عنوان المدرسة (الثانوية الشاملة)! ولم يكن هناك برنامج يُذكر، سوى بعض الألعاب، والمسابقات الخفيفة، ثم كانت مسرحية ختامية، كان قد أعدَّها بعض الأساتذة الملتزمين عن مشكلات الشباب، والتي كان ختامها أنشودة (مؤامرة تدور على الشباب) وهي من ضمن شريط (الدمام1)! في هذه الرحلة تعرفت على شخص كان أصغر مني بسنتين، ولا أدري لعله حينها كان في السادس ابتدائي، أو أول متوسط، وكان صامتاً جداً، قليل الحركة، قليل المشاركة، اضطررت أن أتعرف عليه حينها، لأنه كان بجواري في الفصل -عفواً- غرفة النوم، إنه أخي وصديقي الشاعر الأديب والشيخ الأريب، والخطيب، والكاتب والإعلامي، عميد كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى الدكتور: (عادل باناعمة!). وفي مرحلة الثالث متوسط بدت علائم (التدين) لأستاذ التفسير، وكان من أهل مكة، ولأول مرة نؤدي صلاة الضحى في المدرسة في الفسحة، ولأول مرة نجتمع في مسرح المدرسة، فترة الفسحة، بعيداً عن الضجيج والصخب. وكان أستاذاً عاقلاً وحكيماً، لأنه لم يفرض أي لقاءات أو دروس أو ما شابه ذلك فترة الفسحة، لأننا في مدرسة وكل وقتها تعليم! ولكنه كان يجمعنا، ويجلس معنا للمؤانسة، وتبادل الرأي العام، وأحياناً كثيرة يسمح لنا بالاستمتاع في المسرح، لنجلس كل إثنين، أو ثلاثة، أو أكثر، و(نتحكى) أو نتبادل القصص، وكان يعطينا الخيار، لمن رغب أن يشارك في اللعب أو المذاكرة أو الحوار أو... نعم كنت أحب اللعب (كرة القدم) ولكن داخل البيوت في الأعم الأغلب، وأحياناً ألعب بجوار منزل الأخ والصديق والمحاضر والمدرب، أستاذ التربية البدنية بجامعة أم القرى، الأستاذ (بدر فلاته)، والذي هو حالياً (مدير فرق فور شباب)!! إن مرحلة (المراهقة) بالنسبة لي كانت لطيفة وسهلة وبريئة، وإن لم تخل أحياناً من آحاد المضاربات (الفزعات)، والتمرد على الذات، والخلل في الأولويات!!
|
|
|
 المراهقة العلميَّة والثقافية! لا أدري كيف تخرجت من المتوسطة، إذ ليس هناك شيء ممتع، أو مما يسر ذكره كمكتشفات علمية أو مواهب فنية أو حتى رياضية! كل ما في الأمر أنها مرحلة وانتهت. وحانت الدراسة في المرحلة الثانوية، وسجَّلت في ثانوية (القدس) بحي الأمير فواز الذي أسكن فيه، وكانت مدرسة جديدة، ورقم تسجيلي فيها (70). لم يكن فيها أي مظهر حضاري أو تعليمي! فليس هناك شيء يفتح النفس، كالورود أو الزهور أو حتى الأغصان المتدللة، كما لم يكن هناك أي كرسي أو طاولة للدراسة. وطُلب منا أن نشتري الكراسي والطاولات ونحمِّلها في السيارات وندخلها داخل الصفوف! ثم طلب مدير المدرسة أن من يأتي (بشتلة) زراعية صغيرة، سيعطى (10) درجات، توهب له في الوقت الذي تراه المدرسة! وليس في ما مضى عجب كبير، بل العجب فيما هو آت من ناحية طبيعة الدراسة. فقد قيل لنا: أنتم طلاب ثانوية شاملة، بمعنى أنكم مثل طلاب الجامعة، الأبواب الدراسية مفتوحة، وأنتم تختارون المواد والأقسام التي تشاؤون، وتتحملون مواد الدراسة وآثار الغياب، وخلافه. والحقيقة أننا كنا جميعاً شباباً (طازة) لا نعرف عن هذه النظم والقوانين أي شيء، ولم يخبرنا أحد بما هو الأولى بمصلحتنا! كان هذا العام (1407هـ). جلست أنا وخمسة من أصدقاء الحي، وتبادلنا أطراف الحديث، ووجدنا أن الثانوية إما أن تختار فيها القسم الأدبي، وهو يشمل: اللغة أو الدراسات الإسلامية أو الاجتماعية، وإما أن تختار قسم العلوم، وهي تشمل قسمي: (كيمياء أحياء) أو (رياضيات فيزياء). ثم طلبوا مني الاختيار، فملت مع أصحاب (كيمياء أحياء) لأن أحداً ممن اختارها هو الأقرب إلى منزلي ونفسي فحسب!! وبدأنا نخبط خبط عشواء ، ننزل المواد في كل قسم بأنفسنا، ولكم أن تتخيلوا شباباً من خريجي المتوسط يديرون حياتهم العلمية من خلال جداول وخطط لم يعرفوا عنها أي شيء، سوى شذرات من بعض المعلمين المصريين آنذاك! وصار حالنا، كما قال د. القصيبي: أنا أمامك.. أفكارٌ ممزقة وحيرة.. وحماس ضائع السبلِ لم ترتشف من ينابيع الرضا شفتي ولم تنور براكين السنى مُقلي ما زلت أبحث عن درب لقافلتي ما زلت أسأل عن معنى لمرتحلي! ومن عجائب الدراسة أنه يحق لكل طالب أن يغيب (5) محاضرات في أي مادة بلا عذر، وبعدها يحاسب ولربما يتعرض للرسوب، والغياب بلا عذر يخسِّر الطالب (نصف) درجة. وكنا ندخل المدرسة وكأننا ندخل سوقاً تجارياً، أو ملعباً رياضياً! فالأبواب العامة للمدرسة مفتوحة، أناس يدخلون وآخرون يخرجون، طلاب يلعبون وآخرون يأكلون ويشترون. ولكن رغم ذلك كله لم تكن هناك مؤثرات ومغامرات كبيرة، لأن (99%) من طلاب الثانوية ليس معهم أي سيارات. وأنا وكل رفاقي كنا نأتي إلى المدرسة بالدراجات ، رغم أننا في حي مرموق (فلل حي الأمير فواز)! ولما وصلنا (الثاني ثانوي) اشترى أحد الأصدقاء سيارة هوندا موديل 80م!! وكنا نخرج جل الأوقات من المدرسة ، لتغيير الأجواء، في رحلات إمتاعية بريئة، وأحياناً مراجعة لبعض ما يقوله الأساتذة، وكنا نحسب كيف نغيب (5) محاضرات من كل مادة، وهي النسبة النظامية للغياب! وأعتقد أنه لا تثريب علينا تلك الفترة، فقد كانت الأوضاع شبه فوضى. وأحياناً كثيرة كنت آخذ الدراجة التي أربطها في حديد منارة مسجد (علي بن أبي طالب) بحي الأمير فواز الشمالي، وأذهب إلى البيت، وأقرأ هناك، أو أراجع أو أستفيد من الوقت. ولربما بعض الأحيان أذهب إلى صديق لي ، كان طالب علم جيد، ويكبرني سناً، فأصلي في داره صلاة الضحى، ونقرأ من مكتبته، ونتبادل القصص والفوائد، وخاصة في التفسير. إن مرحلة الثانوية مرحلة خطيرة إذا لم يجد فيها الشاب الموجّه الناصح، وإذا لم ينظر فيها إلى المستقبل الواعد، وإذا لم يوجد من يراقب مسيرته التعليمية بشكل صحيح، وما ينقصها ليتمم ما فيها من خلل. وهذه هي زبدة هذه المرحلة باختصار. المهم أن المولى جلَّ جلاله أعان على التخرج من قسم (الكيمياء أحياء)، وملت إلى الجانب العلمي ، وكنت أتابع وبشدة برنامج الشيخ الزنداني عن الإعجاز العلمي، واهتممت بهذا العلم، وتابعت الكتب القليلة، بل وحتى بعض المجلات التي يحضرها لي صديق في الخطوط السعودية، لقراءة ومتابعة كل ما يتعلق بالإعجاز العلمي. وكنت أحلم أنني سأكون من المبدعين في هذا المجال، الذين يمكثون في المعامل للتحليل، والوصول إلى المخترعات والمكتشفات العلمية التي أربطها بالإيمان. وكنت أجمع الصور والوثائق، حتى أعددت قرص كمبيوتر، يعمل فقط على كمبيوتر صخر (386)! فيه مئات الصور العلمية المنتقاة من مئات المجلات، إضافة إلى جوانب الإعجاز العلمي فيها، وطلبته إحدى المؤسسات لبيعه ونشره، ولكني آثرت أن يكون منسوخاً بلا ثمن، لأن العبرة بنشر الحقائق لا بكسب الدراهم! وكنت تلك الفترة مشدوداً جداً إلى الكتب الثقافية ، وخاصة فترة الإجازات، فوالدي -رحمه الله- كان يملك مكتبة ثريَّة منوعة، بحكم علاقاته الكبرى بأهل العلم والفضل. ففي الثانوية قرأت كتباً غريبة التنوع مثل شرح بلوغ المرام، وشرح عمدة الأحكام، وزاد المعاد، والمستطرف، وكتب الطنطاوي، وسيد قطب! إنها تشكيلة غريبة وعجيبة، لم يأمرني بها أحد، ولم يمنعني عنها أحد! أتذكر والله أنني قبل وبعد كل صلاة أقرأ من زاد المعاد، وظللت على هذه الطريقة حتى فرغت من الجزء الثالث، وهو بتحقيق شيخي الأول ومعلمي الأكبر، العلامة المحدث: عبدالقادر الأرناؤوط -رحمه الله-. كما إنني بعد عودتي من المدرسة كنت أقرأ في شرح الأحكام، كل يوم قرابة خمسة أحاديث، وأسجل ما يصعب فهمه، لأسأل عنه سماحة العلامة عبدالله بن بيه ، والذي كان ولا يزال جاراً لنا. كما أتذكر الآن وبشكل عجيب أضحك منه أنني قرأت كتاب: معالم على الطريق، للأستاذ سيد قطب، وأنا على الرصيف فترة الصيف، عندما أذهب إلى إحدى النوادي الصيفية، ولا يعجبني البرنامج الرياضي. كل ما في الأمر أن عقلية والدي ، المعروف بسلفيته، وأفتخر بها، وأدعو لها، لم تكن مأزومة أو منكفئة على نفسها، بل كان يفرح بأهل العلم، وكل ما في كتبهم من فرائد وفوائد كما أن والدي -رحمه الله- كان يفرح إذا ذهبت إلى المكتبة واشتريت كتباً متنوعة، فأرى من احتفائه ونظراته أنه كان يأخذ بعضها إلى حجرته فيقرأ منها، ثم يخبرني عما استفاده منها! وقد ألهمني المولى جل جلاله أن أضع لنفسي جدولاً للقراءة في كتب منوعة، إلى أن وصلت المرحلة الجامعية، وجالست الكثير من العلماء والمفكرين والمتخصصين في قضايا علمية مختلفة، أثر في وضع الأولويات، وبناء المنهجيات. وأحمد الله أنني لم أكون مشوشاً، أو مستعيراً لفكر أحد، رغم أن أحد قرابتي كان ينصحني وأنا في الثانوية بترك كتب فلان وفلان، ولكن رحمة الله لي كانت أقرب، فرغم لصوقي به، وشدَّة قرابتي له، ورغم علميته الجيدة، ومكتبته العامرة التي سحرتني، وشدتني لزيارته كل أسبوع. أقول: رغم ذلك كله، كانت رحمة الله أقرب، فبصَّرني أن لا أقع في فخ الاتهام لأحد، أو التشويش الفكري ضد أحد. ومرت مرحلة المراهقة التعليمية والثقافية بسلام -والحمد لله- وإنني اليوم لأحمد الله كثيراً، كلما رأيت أو سمعت أو عاصرت من الشباب الذين عاشوا مرحلة الثقافة الشرعية والفكرية والدعوية على حساب شخصيات محدودة، ونظرات أفراد محدودي الفكر، متقوقعي الجغرافيا، أحاديي النظرة! ومن نافلة القول: أن أذكر أن دعاء الوالدين ورعايتهما كانت سبباً للحصانة، وأن أخلاق ومنهج بعض الأساتذة الذين تعرفت عليهم، واقتنعت بصدق توجههم، ساندت في تشكيل هذا الانطباع، والإيمان به.
|
|
|
 ذكريات تربويّة وإيمانيّة أرجو ألا تكون اللحظات الجميلة في حياتي قليلة وسريعة! أبدأ بذلك لأني سأروي لحظات لا يمكن أن أنساها، ومواقف لا يمكن أن يزول أثرها -بإذن الله-، ولكنها قديمة! من هذه اللحظات السعيدة والسارة في حياتي الثانوية حبي للخلوة والنظر في السماء! كنا نذهب مع أصدقاء الحي، وزملاء المسجد في رحلات بريّة، وكانت من الفقرات المؤنسة، أنّه في آخر الليل نجلس أو نمد ظهورنا على الأرض ، ونسمع إلى الآيات التي يؤديها أحد القراء عبر المسجل، كصدر سورة يونس، والروم، مما تتضمن ذكر خلق الله تعالى وعظيم وبديع صنعته. كنا نتخيل الجنة ، والمأوى الذي نعمل له، نتخيل حجمنا مقارنة بالسماء العظيمة، نتأمل لحظات الخلود، نتأمل عظمة الله وضعف إمكاناتنا وقدراتنا ومدى تجاوزنا. ولأن هذه الطريقة كانت عن صدق ورغبة في التأمل الحقيقي والإصلاح الداخلي ، كنت كل يوم وأنا طالب في الثانوية أذهب إلى سطوح المنزل، وآخذ مسجل يدوي صغير بحجم الكف، وأسمع القرآن وأنا ممتد على سجادة، حتى إذا فرغت من سماع السورة، أقوم لأصلي الوتر. ومن اللمسات الإيمانية الراسخة في روحي والممتدة في كل كياني إلى الآن ، أن أستاذنا المربي الدكتور: عدنان فقيه -حفظه الله-، كان يختار لنا صوراً من مجلات عن عظمة الله وبديع صنعته في الكون وفي الإنسان، ويعدها على شكل (سلايد)، وهي عبارة عن صور داخل مربع صغير تقلب صورة صورة بعد وضعها في جهاز، وكان يختار أناشيد إيمانية مناسبة لتسلسل الصور كأنه مخرج وهو كذلك، ولكنه مخرج إيماني! ومن تلك الأناشيد مثلاً، أنشودة: إنه الله القدير، وأنشودة: قل للطبيب تخطّفته يد الردى، ولا تزال ألحانها وطريقة أدائها مصحوبة مع الصور، تشعرني بالغبطة الإيمانية، والتواضع لله، وحب التجليات الربانية. لقد كانت أساليب أستاذنا في قمة التحضر الإيماني ، وكان واعظاً صادقاً في موعظته، وبليغاً في أداء الأساليب التي تزكي القلب، وترقي الروح. وكان صاحب عبادة وزهد، وتقوى وتألُّه، وأوراد وتلاوة، غمرنا بالمعاني التربوية والإيمانية، وأشهد أنه كان آية في فهمه للقرآن وتأمله فيه، وتمسكه به. كل ذلك مع تمام المحافظة على منهج أهل السنة، والتقيّد بآثار الشرع، التي كانت لمساتها عنده غير جافّة ولا صعبة! ومن اللمسات الإيمانية التي غذّتني مرحلة الثانوية كثيراً، الحفاظ على صلاة الفجر جماعة والمواظبة على درس التفسير اليومي. فقد كان أستاذنا (د. عدنان فقيه) ومعه أستاذنا الأجل (حسن شاهين) يحضران في آخر مسجد الفتح بعد صلاة الفجر كل يوم، ويَقرأ كل منا صفحة من القرآن، ثم يقوم أحدهما بالتعليق على بعض الآيات المختارة، وننصرف بعدئذ للاستعداد للمدرسة. أما يومي الخميس والجمعة فقد كنا نستمر إلى الإشراق، ثم نزاول نشاطنا الرياضي أو الاجتماعي في البحر، أو الاستمرار في الصيام، كل ذلك حسب الحال. وأحياناً كان يقرر أستاذنا (فقيه) أن نصلي الفجر عند إمام قارئ تؤثر تلاوته فينا، ولمدارسة بعض معاني القرآن في الطريق. فكان يمر عليَّ وأنا في مرحلة الثانوي قبل آذان الفجر بدقائق ، ليجدني مهيئاً، لنسير في رحلة إيمانية قلَّ نظيرها. إن هذه اللمسات الإيمانية تسكب في قلب الشاب معاني راقية، وتؤسس في نفسه قيماً عميقة خالدة، وتغازله نفسياً ليؤوب ويمضي على نفس السيرة لأنها كانت صادقة، ولم أجد في الحقيقة وصفاً لواقع هذه اللمسات وأثرها الطيب على نفسي مثل ما وجدت في قصة قريبة للداعية محمد الراشد مع أبناء جيله في صلاة الفجر إذ يقول: "يوم كانت الهمّة تامّة لم تنحت منها السنون بعد: كنتُ أجمع بعض إخواني الدعاة في جامعة بغداد، بعدد قليل دون العشرين كل أسبوعين، لنقوم الليل ونتلو القرآن، مع درس دعوي وموعظة مناسبة، ولأن الرقابة كانت هاجسنا: فإننا كنا نتجاوز المساجد الظاهرة العامرة إلى مسجد عتيق رطيب عريض الجدران واطئ الطاقات والأقواس، بالي الفراش، في زقاق ضيق قديم، يسمى "مسجد حسين باشا"، وهو الوالي العثماني الذي بناه قبل أربعمائة سنة تقريباً، ويبدو أن يد الصيانة لم تمتد إليه آنذاك، فكان التلف ظاهراً في أكثر أرجائه، والجص قد سقط من بعض حيطانه. لكن أولئك المائة الروّاد الذين كانوا يتناوبون الحضور أفواجاً صدروا عن إجماع جازم أنهم لم يروا مكاناً تتجلى فيه البركة الربانية ظاهرة كمثل حَرَم ذاك المسجد، وكان أي مشارك يحسّ بروحانية عميقة تحت تلك الأقواس، ويشعر بشعور خاص إذ هو بين تلك الجدران الهرمة يفوق تأثير الموعظة، ويضاعف إخبات القلوب الذي يولِّده التهجد والتغنّي بالآي، حتى إذا حكَمَ وقت أذان الفجر: تصدى لرفع الأذان الحاج أحمد رحمه الله، مختار حي الحيدر خانة الذي يقع المسجد فيه، وكان رجلاً ميسوراً لكنه يسكن غرفة في المسجد تطل على ساحة واسعة، فكان إجماعٌ من إخواني أنهم لم يسمعوا أبداً أذاناً جميلاً آسراً مُطرباً كمثل أذانه، وكان عادل الشويخ يقول: يصح البيات في المسجد ثمناً لسماع ذلك الأذان، وأنا أشهد بما شهد به رحمه الله: أني حتى الآن وأنا في الرابعة والستين ما أتلذذ بسماع نغمات أذان تدق أبواب القلب دقاً كنغماته، وآثار أذانه في نفوس أولئك الدعاة تعدل ما يرجعون به من آثار التلاوة والتهجد. وتفسير هاتين الظاهرتين عندي -والله أعلم-: أن هذا المسجد العتيق قد بناه صاحبه بنيّة خالصة، ثم تتابعت أجيال كثيرة من المؤمنين تصلّي فيه وتدعو، فحباه الله تعالى ببركة خاصة ميّزته عن مساجد أخرى، ثم يبدو أن هذا المؤذن الذي هو ليس بأجير كان على شعبة من الإخلاص واقتراف الحسنات، فأودع الله عز وجل في صوته تلك العذوبة والقوة التأثيرية".
|
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| ذكريات شاب | يمامة الوادي | منتدى القصة | 4 | 2009-12-27 3:17 PM |
| ذكريات ومواقف | يمامة الوادي | منتدى الصوتيات والمرئيات | 7 | 2009-03-05 1:57 PM |
| ذكريات لا تنسى :( | زايرة | المنتدى الترفيهي والمسابقات | 9 | 2007-03-30 1:02 AM |
| ذكريات مفارق | يمامة الوادي | منتدى النثر والخواطر | 2 | 2006-12-20 5:11 PM |
| ذكريات علي سليم | علي سليم | المنتدى العام | 22 | 2006-04-25 8:49 PM |









 العرض العادي
العرض العادي

